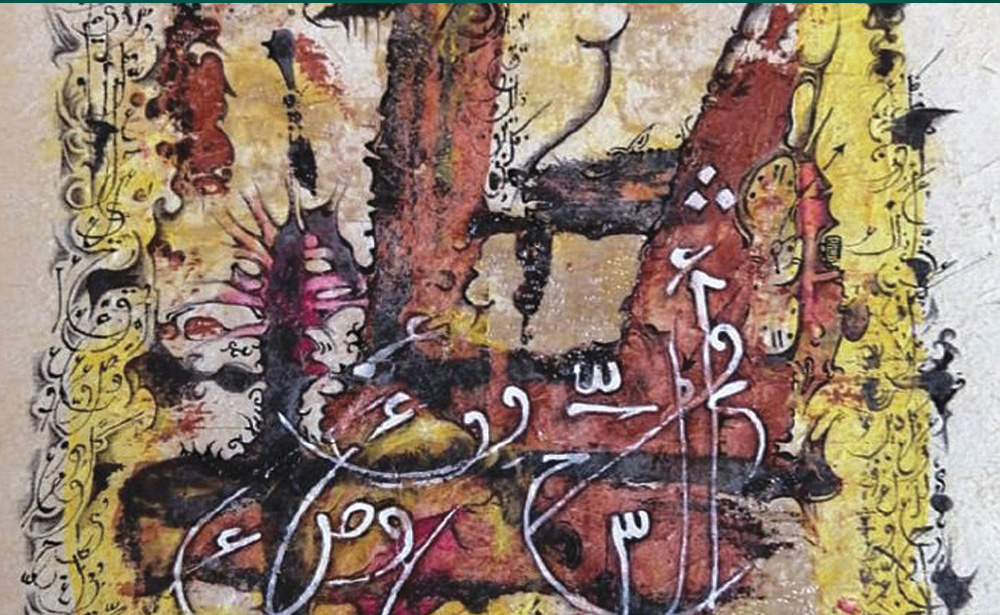إعداد وتقديم: عبدالرحمن المسكري
يتكاثف “التاريخيُّ” في النص الشعريّ العربيّ الحديث، على نحوٍ يتحرّر فيه من الزمن ومتوالياته الحدثيّة؛ متخلصّا من عوالق الخطابيّ والتوثيقيّ، حاضرًا بحمولاته المعرفيّة الرّامزة، بحيث يتعالق التاريخيّ مع الرّاهن لينصهر المعنى في لحظة تَقطُّرٍ شعريّة تتجلى فيها الرؤيا الشعرية للإنسان والحياة والوجود.
ولقد ظلت العلاقة بين النص الشعري والتاريخيّ محلّ بحث أبتسميّ ومنهجيّ، أفرز تنظيرات في المعرفة الأدبيّة تستغور ديالكتيك النصّ الشعري الذي يترافدُ المنابع المعرفية المتعددة، بما فيها التاريخ بحمولاته الدلالية ومقاصده التداولية. فالتاريخ في النص الشعري ليس “الماضي”؛ بل الحضور الماثل والذاكرة الحيّة، وفي “شعرنته” تخليقٌ استعاديٌّ للمعنى التاريخي تتمرأى فيه الذات العربية الراهنة نفسها من جهة، وتوظيفٌ لتمفصُلاته وأحداثه السياسية والاجتماعية لتحقيق مقاصد بلاغية من جهة ثانيّة.
فإذا كان الأثر الأدبي بوصفه إنتاجا، هو مُرتحَلَ نصوصٍ، بحسب عبارة جوليا كريستيفا، تتقاطع في فضائه الملفوظات العديدة وتتنافى؛ فإنه من جانب آخر يقيم علاقات حوارية مع معطيات المحيط الثقافي الراهن، ويُمسرح سياقاته الاجتماعية باعتباره خطابا متصلا بزمن إنتاجه؛ حيث إن النص يعمل وفق توجيه مزدوج: «فهو موجّه نحو النسق الدال الذي ينتج ضمن اللغة التي تنتمي إلى عصر ومجتمع معيّن، وبما أنه يسهم في السيرورة الاجتماعية بوصفه خطابا فهو موجِّه لها من جهة ثانية». بهذا المعنى نلفي الأثر الأدبي متصلا بمجموعة واسعة من النصوص، تنضوي كلها في مصهر الفضاء النصيّ، هذا المصهر الذي تطلق عليه الناقدة البلغارية “الإيديولجيم”، بوصفه البؤرة التي تستوعب داخلها “بعقلانية عارفة” نسيج الملفوظات؛ الراهنة والتاريخية. حيث يمارس “النص الناسخ” عملياته التصحيفية أو “التحويلية” بعبارة جيرار جينيت على النص السابق؛ فينزع عنه سمة القداسة بما يسمح باستدعائه ومساءلته وتفكيكه وإعادة بنائه، ما يحيل إلى أنّ “التاريخي” ليس مقصودا لذاته، بقدر ما هو موظفٌ ومنتقى لخدمة الرؤيا الشعرية.
إن الكتابة الأدبية التي تسترفد المعنى التاريخي لا تعمل على حفظ الذاكرة الثقافية وترهين القراءة لأحداث الماضي وحسب؛ وإنما، أيضا، تستبطن ضربًا من التحليل الذي يلج إلى التمثيلات الثاوية في أعماق التجربة الإنسانية المتعاقبة، حيث يتسع النص الأدبي ليغدو مؤسسة اجتماعية تضمّ خزينا من القيم والأنساق الدالة على المحيط الاجتماعي زمن إنتاج النص ومكانه.
لذا؛ فإن انفتاح المخيال الشعري العربي الحديث على التاريخ بوصفه مرجعيّة ثقافية مؤثّرة في الذهنية العربية المعاصرة، يعكس الارتباط الوثيق والعميق بالتاريخ وسيروراته ومآلاته، بما يحيل إلى أهمية دراسة الأنساق الثقافية والاجتماعية، الكاشفة عن الرؤى والمواقف التي تكتنز بها المدوّنة الشعرية العربية الحديثة.
وحيث إن منطقة الخليج العربي تتواءم في كثير من المشتركات الجغرافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية؛ فإن مقاربات النص الشعري في الخليج العربي ستحيل إلى تلمّس أنساق ثقافية واجتماعية مائزة.
تخصص مجلة ملفًا خاصا حول “شعرنة التاريخ في النص الخليجي الحديث”، حيث يسعى الملف إلى تعميق التّفكير في العلاقة بين التاريخي وتمثيله عبر المخيال الشعري، يقدم خلاله باحثون ونقاد دراسات ومقاربات تحليلية للتجارب الشعرية الوازنة في المشهد الشعري الحديث في الخليج العربي. فتدرس ضياء الكعبي خطاب الشّاعر البحرينيّ علي الشرقاوي، من منطلقات القراءة التناصية الثقافية، التي تنزع إلى توظيف استراتيجيات النقد الأيديولوجي للكشف عن الأرضيات التاريخيّة والاجتماعية والسياسية والثقافيّة في النص الأدبي، في سبيل إيجاد علاقة بين النصوص الفردية والسياقات الجماعية المختلفة. وتخلص الكعبي إلى أن نصوص الشرقاوي الشعرية على امتداد تجربته الأدبيّة تتشكّل بوصفها خطاب تناصّات ثقافيّة كبرى للقصيدة القناع؛ تجاوز فيها الشرقاوي حدود المحاكاة التناصية الطباقية المرجعيّة إلى كتابة خرْقٍ وتفكيكٍ تعيد بناء عوالمه الشعرية بناءً رؤيويًا لشعرنة التاريخ في سردياته الكبرى الاستعادية.
في حين تذهب رانية العرضاوي إلى دراسة مسالك شعرنة التاريخ في النص الشعري الخليجي المعاصر، بوصفها تحريرًا للتاريخ من سمت الوظيفة التحققيّة المعتمدة على المقاصد الضمنية أو المعلنة، حيث تتحرك ثوابت التاريخ وتتغير رواسبه الثقيلة في نسيج شعري تخييلي يُرضي المتلقي “الفرجوي”، فالتاريخ وإن كان رافدًا أساسيًا للشعر الخليجي المعاصر، إلا أنه يخضع لوجود مختلف عبر أدوات الصورة والفرجة والاستعراض، وغيرها؛ استجابة للمتغيرات التي لحقت بالمجتمع الخليجي، وتساوقًا مع موجات التغيير العالمية في طبيعة الحياة وطوارئ العصر.
ويتناول مبارك الجابري توظيف التاريخ قصيدة النثر العربيّة؛ دارسًا نماذج من قصيدة النثر العُمانية، إذ يذهب إلى أن التاريخ بالنسبة إلى قصيدة النثر العربية ليس محض سردية يؤثث بها النص؛ بل هو إثبات لصدق الانتساب إلى السلالة الشعرية، حيث يشكل حضور التاريخ في قصيدة النثر العربية تحديدا، أداة أساسًا لإثبات شرعية وجودها، في سياق أدبي يشكله التاريخ، ويغذي قدرته على الوجود في المجتمع، فيحضر التاريخ في الشعر موظفًا ومنتقى، إلا أن القدرة التخييلية للشعر تخلع عن التاريخ تماسك سرديته فتجعله عرضة لعمل الشعرية، بما هي فعل تفكيكي أساسًا.
أما سعاد العنزي، فتدرس تجربة الشاعر الكويتي خليفة الوقيان، الذي يمثل حضور المعنى التاريخي مدارًا أساسيًّا في نصّه الشعري، حيث تطوف قصائده في مراحل التاريخ؛ مستدعيًا ومسائلًا الخسارات العربية التاريخية لنقد الواقع المأزوم بالنكبات؛ بحثًا عن رؤية تفسيرية لما يعتور الأمة من خيبات متوالية.
ويدرس علي كاظم داود فاعليات التاريخ في نصوص بعض شعراء العراق، حيث تحضر الرموز والعبر التاريخية بهيئتها اللازمانية، للتعبير عن مواقف إزاء الواقع، فضلا عن إسهامها الفني داخل النص، إذ يُستفاد من طاقتها التخييلية أو الرمزية أو السردية، لتوجيه دلالات الخطاب الشعري نحو مقاصد مؤثرة بوصفه في كثير من الأحيان خطابًا مضادًا وفعلًا ثقافيًا مقاومًا، يناهض التسلط والهيمنة والظلم، وينتصر للمضطهدين والمهمشين، ويقوم مقام الذاكرة للمنسيين تاريخيًا.