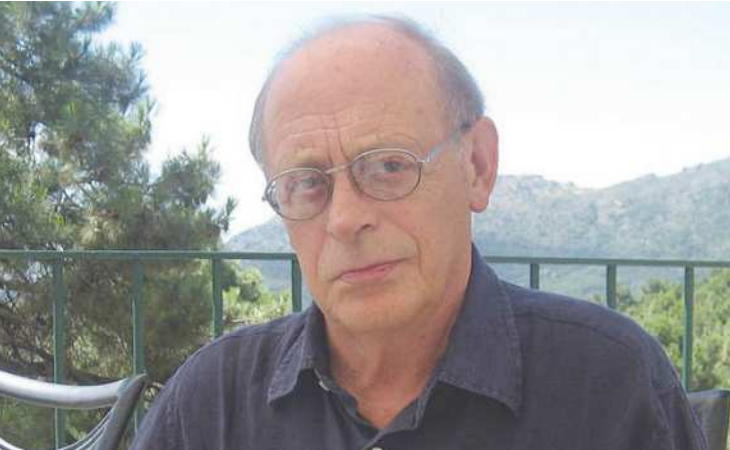ألكسي لييبارت
إعداد وترجمة: محمد ياسر منصور كاتب وباحث سوري
لا تُمثِّل كتابات أنطونيو تابوكي سرًّا غامضًا.. فلديه جاذبية قوية نحو سوء التفاهم… وإذا كان يهوى ذلك الغموض والإبهام الذي يلف حياتنا في كتابه (“سوء تفاهم بسيط دون أهمية”، وظَهَرَ ثانيةً في العام 2006 تحت عنوان “غموضات صغيرة دون أهمية”)، “قد تكون الكتاب الذي يناسبني أكثر” كما يقول الكاتب، فإنه أيضًا شديد الاهتمام بهذا الفهم الجديد للزمن الذي تفرضه علينا حداثتنا، كما يشهد على ذلك كتابه الأخير، “الزمن يشيخ سريعًا” وهو مجموعة قصص. ومنذ النجاح الذي أحرزه كتاب “بيرير بريتند” “بيريرا يدَّعي) الذي استُقبِلَ في إيطاليا وكأنه هجوم لاذِع على برلسكوني فغالبًا ما كان أنطونيو تابوشي يُنظَر إليه من خلال صورة “الكاتب الملتزم”. وفي هذا أكثر من سوء فَهم، إنه فَهم معاكس. إنه يعني أحد الكتَّاب الأكثر رِفعة ،الذي خلَّف وراءه أعمالًا عظيمة تستحق التقدير، والذي يكتب بالإيطالية كما يكتب بالبرتغالية “صلاة لراحة الموتى” ، وهو مُترجِم للشعر وكاتب مقالات. وكاتب “ليالٍ هندية” الذي يقول إنه يحب جَلبة الكائن البشري من حوله عندما يكتب، فهو يُشير هنا إلى افتتانه بالشاعر البرتغالي بيسوا، وإلى حُبِّه للشعر أو الانجذاب الذي يكنّه لشخصياته . إنه يرسم صورة ذاتية للرجل، الذي “أصبح كاتبًا بالمصادفة”.
هنا، الحوار الأخير الذي أجراه معه -قبل رحيله- الصحفي الفرنسي (ألكسي لييبارت)(2).
* بِغَضّ النَّظَر عن التفكير في الزمن، ألا يشكِّل كتابك الأخير (ليالٍ هندية) Nocturne indien أيضًا طريقة لتطويع الشيخوخة وبالتالي الموت؟
– تلك هي المسألة الأبدية الخالدة : لماذا نكتب؟ أعتقد أن جميع الكتب التي نُدوِّنها تحمل فِعلًا بشكل من الأشكال طموح تطويع الموت. وربما نكتب لأننا نخاف الموت. لكن يمكن القول أيضًا إننا نكتب لأننا نخاف الحياة، وهذا معقول أيضًا. فالخوف هو شيء ما يُهيمن على الكتابة، وهذا هو الوقود الذي يُغذِّي مُحرِّك الكتابة.
* وربما كان البحث عن شيء من الخلود…
– لا أحد يعرف كم من الزمن يمكن أن يبقى عمل ما. أنا لا أُعلِّق آمالًا كبيرة على قادِم الأيام. وإذا كان المقصود العَودة إلى كتابي، فإن المستقبل والديمومة والعلاقة بالتاريخ، أي بالزمن العريض، فأنا أعتقد أن الشخصية الرئيسة في هذا الكتاب، هي نوع من الشخصية المفرطة التي تُهيمن على الآخرين جميعًا كما في كتاب “سوء تفاهم بسيط دون أهمية” حيث توجد شخصيات، بل أيضًا شخصية مجازية أكبر كانت تُمثِّل اللبس والغموض. إني أُفضِّل بالأحرى رؤية كتابي كلوحة الرسام الإيطالي أرسيمبولدو، المُشكَّلة من عناصر مختلفة، والتي عندما تنظر إليها من مسافة بعيدة تجدها تُشكِّل صورة ما، وهي الصورة التي تُؤطِّر جميع الشخصيات. وهذه الصورة، هي الزمن بالتأكيد، زمن الحداثة الذي يستهويني أكثر فأكثر. لقد أَلَّفتُ كتابًا بعنوان “الوقت متأخر، ويزداد تأخرًا”، أبحث فيه عن أن أقبض بشكل من الأشكال على أن أعيش الزمن في حداثتنا.
بعد كتاب “تريستانو يموت” حيث تجد نوعًا من الديالكتيك بين زمن التاريخ وزمن حياة الشخصية، كانت لَديَّ الرغبة في أن أَنكبّ على هذا الطراز بأن أعيش زمني الذي لا ينتسب إلَّا إلى حداثتنا. وكان لَدَيَّ ، في الواقع انطباع بأن شعورنا بالزمن يختلف اختلافًا كافيًا عن الزمن الذي عاشه الناس في عصور أخرى. وأعتقد اليوم أن في حداثتنا المستقبلية ثمَّة تفاوت هائل بين زمن الشعور، أي زمن الشعور والإحساس بحياتنا، بِزَمن الديمومة، كما قال الفيلسوف الفرنسي بيرغسون، والزمن الخالي، الذي جَرَت فيه كل الأشياء المسمَّاة بالتاريخ، أو بالأحرى الأحداث. وأعتقد أن بين الحَدَث والوعي ثمَّة تفاوت كبير جدًا، وربما كان هذا ما يُثير الاضطراب في الحركة الاجتماعية وسير عملها، وحتى في الاقتصاد.
* لماذا اخترت مجموعة قصصية؟
– لقد كتب “ميلان كونديرا” نصوصًا رائعة حول ما يسمَّى الرواية الحديثة. وممَّا قاله إن الشعور بالزمن الذي يُنهي الرواية التقليدية، يختلف تمامًا عن مَثيله في الرواية الحديثة. فربما كانت الرواية الحديثة مُشكَّلة من مقاطع وأجزاء ومقتطفات، وأُحبّ كثيرًا البُعد الذي تتَّصف به القصة القصيرة، والأقصوصة. إنه قياس موسيقي يختلف تمامًا عن مقياس الرواية، لأنه كما يقول الكاتب “جوليو كورتازار”: “كاتب الأقاصيص يعرف أن الزمن ليس صديقه”. وكتابة أقصوصة كما الشاعر عندما يكتب قصيدة فروسية أو قصيدة من 14 بيتًا (سونيتا). وهذه السونيتا لها شكل مغلق، وهي إذًا تَحدٍّ كبير لمن ينظمها. والحال نفسه في الأقصوصة، إذ يمكن جَعل أحداثها ضمن مجال زمني محدود جدًا، لكن لا يمكن التخلِّي عنها في منتصف الطريق. فإن أنت تَركتَ أقصوصة دون أن تنجزها أو عُدتَ إليها بعد ستة أشهر، ستلاحظ أن هذا غير ممكن. أمَّا الرواية، فهي تنتظرك، إنها صبورة جدًا. ويمكنك تَركها، والرحيل إلى أقصى الدنيا، والعَودة بعد سنة، فستجد أنها تنتظرك صابرة. إنها بيتك، إنها لَك. أمَّا الأقصوصة فهي شقَّة مُستأجَرَة؛ إن تَركتَها دون استئذان، فإن المَالِك سيقول لك عند عَودتك: “آسف، لقد سَكَنها غَيرك”.
* لقد كشفتَ طَواعيةً أنك مفتون بقراءة “تاباكاريا” لفرناندو بيسوا…
– هذا صحيح ، كنتُ مفتونًا لكونه يستخدم في الشعر الشكل الروائي. وقد تَوصَّل من خلال شِعره إلى صَوْغ روايات أو مسرحيات. وهذا صعب جدًا. وهذا يعني إذًا أن تكتشف في قصيدة نُظِمَت في الثلاثينيَّات حَداثة درامية بالغة الوضوح، نَعم، هذا ما سَحَرَني. و”بيسوا” كأنه “الكوميديا البشرية” في أبيات شعرية: فالبنية والصياغة كما في الرواية، من حيث الفكرة الرومانسية.
* هل لـ “بيسوا” تأثير كبير فيك؟
– كل شيء يُؤثِّر فِيَّ. فأنا من ناحية ثانية أدهش لِسَمَاع بعض الكتَّاب يقولون: “أنا لم أتأثَّر أبداً بشيء، أنا أصيل تمامًا”. وأعتقد -كما يقول”فيليب روث”- أن “الكاتب الجيِّد يسرق، والكاتب المحدود يُقلِّد”. وفي الأعماق، نرى أن الكاتب لِصّ دائمًا. فهو يسرق الواقع، ويسرق قصص الآخرين. إنه متلصِّص ومُستَرِق لِلسَّمَع.. إنه يسرق، ويفهم وينقل إلى الآخرين. إنه شَرِه.
* لكن هل قراءة قصيدة لبيسوا جعلتك تُقرِّر أن تصبح كاتبًا؟
– كلَّا، أصبحتُ كاتبًا بعد ذلك بقليل، فَنَشَرتُ أوَّل رواياتي وعمري 32 سنة. وفي الواقع، أصبحتُ كاتبًا بالمصادفة، جرَّاء المَلَل. كتبتُ أوَّل رواياتي لأنني كنتُ أشعر بالمَلَل. ولْأَقُلْ لَك كل شيء، فقد كنَّا في المدينة، وكان الوقت صيفًا، ولم يكن بوسعنا الحَرَكة لأننا كنَّا ننتظر مولودنا الأول. كنتُ باحثًا في دار المعلمين العليا في مدينة بيزا. ولأُمضي الوقت آنئذٍ وأُسلِّي نفسي، بدأتُ الكتابة. وأقول (التسلية) لأن الكتابة لَعِبٌ أيضًا، لكنه لَعِب جادّ جدًا. فالكتابة تمدّ المرء بالآلام والأحزان، لكنها تمدّه أيضًا باللذة والنشوة. أَنهيتُ الكتاب، وتَركته لَديّ، ولم أكن أتمنَّى نَشره، كنتُ مدرِّسًا وباحثًا وفقيهًا لغويًا، وكنتُ منشغلًا بالمخطوطات الباروكية ولا سيَّما الإسبانية والبرتغالية. كانت تلك مهنتي، وكانت من ناحية أخرى هي حياتي. وتابعتُ تدريس فِقه اللغة. وبعد مضي سنتين، كان مدعوًّا لَديّ إلى العشاء في المنزل أحد الأصدقاء، وهو”أنريكو فيلبيني”، الذي يُدير دار نشر بومبياني، ورأى المخطوط، فَأَخذه وقَرأه وقَرَّر نَشره. إنها المصادفة إذًا، لكن كما يقول فيكتور هوغو: “المصادفة إن وُجِدَت فهي بارعة جدًا”.
* تعلَّمتَ اللغة البرتغالية، حتى إنكَ كَتبتَ رواية بالبرتغالية وهي “روكيوم Requiem”.
– عندما كنتُ فَتيًّا جدًا، جِئتُ إلى إيطاليا بعد أن قرأتُ لأول مرَّة أعمال الشاعر البرتغالي فرناندو بيسوا، واكتشفتُ في قِسمي في الجامعة أنهم يُدرِّسون اللغة البرتغالية. فَقلتُ في نفسي: “يا لها من فرصة مناسبة لِتعلُّم لغة هذا الشاعر الفريد. إنها إذًا لغة تَعلَّمتها وأنا بالِغ. وإذا كنتُ اليوم أمتلك لغتين، فهذا غير طبيعي كما يقول اختصاصيو فقه اللغة. وليست البرتغالية لَديَّ في مستوى الإيطالية. وَلنَقُل إنني وُلِدتُّ يافعًا في بيئة غير بيئتي. فَلَستُ إذًا الشخص نفسه عندما أكتب بالإيطالية أو بالبرتغالية. مع العِلم أنني عندما كتبتُ “روكيوم” بالبرتغالية، كان الأمر سهلًا جدًا. ففي أحد الأيام، استيقظتُ في باريس وتأكدتُّ من أنني قضيتُ الليالي الأخيرة، وأنا أَحلمُ بالبرتغالية. والواقع، أعتقد أنك عندما تكون أحلامك بلغة ما، فَأنتَ تمتلك ناصية هذه اللغة بِعُمق، وهي صنوان روحك. فهي لم تعد أداة اتصال فحسب. وعندئذٍ بدأتُ أُدوِّن الحوار الذي دارَ في ذلك الحلم باللغة البرتغالية طبعًا. ثم تابعتُ كتابي باللغة نفسها، وبَدا لِي ذلك طبيعيًا.
* أَلَستَ أنتَ نفسك في الإيطالية وفي البرتغالية؟
– كلَّا. إن اللغة هي أيضًا أسلوب وُجود. إنه سِيَاق مختلف، عالَم ثقافي، تاريخ مختلف. ومن يكتب بالبرتغالية هو أيضًا صديقي القديم، هو أنا، لكن في شخصٍ آخر. وعندما تكتب بلغة أخرى فَأنتَ بوضوح تُواجِه الآخر، جَرَّاء كَوننا أكثر من شخص، بل نحن جماعة.
* تَرجَمتَ العديد من القصائد من لغات مختلفة. فعندما تُتَرجِم ، هل تنسى الكاتب الذي هو أَنت؟
– نَعم. تَرجَمتُ لبيسوا، بل أيضًا لإميلي ديكنسون وبعض القصائد لرامبو التي لم أنشرها بَعد والتي أحتفظ بها في أحد الأدراج. إنني قارئ نَهِم للشعر، لكن كتابتي لا تنتمي إلى هذا العالَم، فقد أكون غير قادر على كتابة الشِّعر. وأُحاول القيام ببعض الترجمات التي أَصِفُها بأنها “ترجمات خَدَميِّة” فأنا أَضع نفسي في خدمة الشاعر. فَترجمة الشعر بالنسبة لي تدريب أكثر قُربًا إلى التقليد منه إلى الحِفْظ عن ظَهر قَلب؛ والترجمة للشعراء، هي الاندفاع في محاولات وِديَّة. وذلك لا يعني بأي حال من الأحوال دَبلَجَة أو ترديدًا للكلمات نفسها لكن بصوته الخاص.
* في كُتُبك ، يشعر المرء أن شخصياتك تبحث باستمرار عن ذاتها، عَبر الآخرين، عَبر الحياة…
– ربما كان في أعماق حياتنا لا يوجد سوى تَقَصٍّ عن ذاتنا. حتى بمجرَّد سَرد مجريات حياتنا، بل ومجرَّد سَرد وقائع يومنا، فإن ذلك يُشكِّل أسلوبًا للبحث في فَهم من نحن وما هي رؤيتنا. فالحياة لا منطقية إلى حَدّ كبير ولا يمكن إدراكها إلاَّ عندما نحتاج بالضرورة أن نُسبِغَ عليها شكلًا قصصيًا منطقيًا، قادرًا على ربط الأحداث فيما بينها. وهذه في الواقع الرغبة في إعطاء معنى لحياتنا، وبالتالي لِذَوَاتنا.
* قُلتَ يومًا: “الخيال والأدب شكل من المعرفة”. ففي الأدب نُدرك ما تُريد أن تقول، لكن، بالنسبة لِلخَيَال، كيف يمكن أن يكون شكلًا من المعرفة؟
– لأنه حتى في البحث العلمي، لا يمكن إحراز تقدُّم من دون الخَيَال. يجب وَضع فَرضيَّات. والتصوُّر بعد ذلك. ويجب أن يكون لَدينا حَدْس، لأن الحَدْس أو البَديهة هو أيضًا شكل من المعرفة التي تسبق المَنطِق، بل شكل من أشكال الذكاء. وطبعًا بين الخَيَال والفنتازيا، هناك فَرْق كبير.
* بالنسبة لَك، هل الأدب حِرْفة، ضرورة، هواية؟
– إنه الثلاثة معًا. إذ أشعر أحيانًا بالحاجة إلى الكتابة. وهذه ليست حاجة فسيولوجية كالحاجة إلى الأكل أو الشرب، بل رغبة جامحة جدًا ولا يمكن مقاومتها. فالكتابة ليست مهنة، بل صنعة بالتأكيد، وفي قُبولِها أَسمى حِرَفيّة لهذه العبارة. فهناك كتَّاب يُحوِّلون الموهبة إلى أسطورة وكذلك الإلهام، وهذا كله طبعًا، إضافة إلى الرغبة والخَيَال، أمور هامة جدًا. لكن الحقيقة أيضًا هي وُجوب المكوث زمنًا طويلًا، والكتابة، والعمل، كما الساعة التي تعمل بِدِقَّة متناهية. ومن دون العمل، يصبح الأدب (صَمتًا وفَرقَعة أصابع). وعندما يطلب مِنِّي كتَّاب شَبَاب النصيحة، أرفض إسداءها إليهم، أو بالأحرى لا أُسدي إليهم سوى نصيحة واحدة: إن كان هناك نَجَّار في حَيِّهم، فَليَقضوا المساء وهم ينظرون إلى الأرض قبل أن يغلق مَحَلّه…
* عندما تبدأ كتابًا، هل تضع مخطَّطًا ما؟ وهل تضع كل شيء في مكانه في مخيِّلتك؟
– في الواقع، لكل كتاب متطلَّباته. وعادةً لَديَّ فكرة مبهمة أحيانًا حول الدروب غير المنتظرة. وتُصبح الشخصيات بعض الأحيان مستقلَّة إلى درجة تحتاج معها إلى تأكيد فَرديَّتها. ولا يمكن الادِّعاء بالتطويع التام لحيوان متوحش؛ فالواقع أن الكتابة حيوان متوحش. وفيها شخصية تعتقد أنها ستكون الشخصية الرئيسة، ثم وفي لحظة معيَّنة، تخرج تلك الشخصية من المشهد وتدخل أخرى لتحلَّ محلَّها. والكاتب يضع خطَّة طبعًا، لكن ليس هذا كل ما يحدث في السينما، حيث كل شيء يسير حسب النَّص. ففي الكتابة يَزجّ المرء بنفسه في مغامرة ويرحل فيها.
* دَخلتَ في جِدال مع أمبرتو إيكو حول دَور المثقَّف…
– ليس جَدَلًا تمامًا. فَفي بداية البيرلسكونية، كَتَبَ في إحدى الصحف أن على المثقَّف التزام الصمت، وأن هناك الكثير من الإشاعات، والكثير الكثير من الأشخاص الذين يتكلمون. وأضاف أن المثقفين يُبرهنون على غَطرستهم عندما يُطالبون بالحقّ في معرفة ما وراء الواقع الواضح، ويستخدمون هذه التورية، فالمثقَّف مواطن كالآخرين، وإذا احترق منزله، فعليه استدعاء الإطفاء كما يفعل المواطنون الآخرون، وأنا أَجَبتُ بكلمتين، بأنني إذا احترق بيتي سأستدعي الإطفاء طبعًا، لكن قد أَودّ علاوةً على ذلك معرفة ما إذا كان سبب الحريق حصول تماس كهربائي أو زجاجة مولوتوف حارقة. وأعتقد أن هذا هو دَور المثقَّف: السَّعي لمعرفة أكثر مِمَّا تقوله السُّلطات بقليل.
* ومع ذلك يتحدَّثون عن دَور المثقَّف، ألا تشعر أحيانًا أنهم يقرأون في كُتبكَ أمورًا مفرطة السياسة؟
– لقد حَصَل هنا، ولا سيَّما في كتابي “بيريرا يَدَّعي” (بيريرا بريتند): فالكتابة السياسية تُبطِّن الكتابة الأخرى، وبالنسبة لي هذا أكثر أهمية: فهو كتابة وجودية. لأن هذه الرواية رواية استبطانية لحياة ما، لعودة الوعي. والظروف التاريخية تُحدِّد الكتابة في بعض الكتب. وكتاب “بيريرا يَدَّعي” يتحدث عن فاشية سالازار. وإذا كنتُ اخترتُ كتابة هذه الرواية، فإن اللاَّشعور لَديَّ جعلني أشعر بالرياح الرديئة التي تهبّ على أوروبا والتي ذَكَّرتني بأحداث الثلاثينيات: ذَكَّرتني بشيء من الوطنية، بشيء من كره الأجانب. والواقع أنه بين الفَينة والفَينة، لم يكن لذلك أي علاقة بكتابي، وقد وصل بيرلسكوني إلى السُّلطة، وأول نَقد لكتابي ظَهرَ في إحدى صحفه “الجريدة”، تحت عنوان “رواية بريجنيفية”(3)، إنهم إذًا هُم الذين اعترفوا بذلك في روايتي والذين قادوا إيطاليا كلها إلى قراءة هذا الكتاب بِوَصفه رواية ضد بيرلسكوني. إنها مثال بليغ على القراءة التي حدَّدتها الظروف التاريخية. وهذا لا يعدو أمرًا تقليديًا. وَخُذ مَثَلًا على ذلك كتاب “دون كيشوت”: فعندما كَتبَ سرفانتس هذا الكتاب، كان حَملة ضد روايات المغامرات؛ وبِبُروز الأخوين ليميير مؤسِّسَي السينما، أصبحت قراءة ذلك الكتاب يُنظر إليها بمنظار آخر؛ وجاءت بعد ذلك الروايات الرومانسية، ثم التحليل النفسي.. وفي كل مرة كانت تختلف القراءة…
* في رواياتك، لا تُمثِّل شخصياتك الرئيسة أبدًا “أبطالًا” بالمعنى الحقيقي للكلمة…
– في الواقع ودون شَكّ، ، لأن الشخصيات البطولية بالمعنى الرومانسي، أو بالمعنى التقليدي للكلمة، تُثير في نفسي شيئًا من الخوف. ولتكون الشخصية بَطَلًا حقيقيًا، يجب أن تكون لا شعورية، ويجب ألاَّ تشعر بالخوف خصوصًا. وأنا أخاف الأشخاص الذين لا يخافون. أنا أُفضِّل الأشخاص الذين يخافون. فالخوف شكل من الحكمة والتعقُّل، والخَوف من صفات البَشَر.
* في نهاية كُتُبِك، غالبًا ما تروي تاريخ شخصياتك…
– ليس ذلك تاريخهم حقيقةً. إنني أُقدِّم دلالات وإشارات، ودروبًا مرسومة. لأنني أنا أيضًا، قد أُفضِّل جيدًا معرفة أين وصلوا، وكيف وصلوا، وهذا غريب للغاية. فلماذا، وكيف، يمكن لكائن شَبَح أن يبرز في شعورك، ويكتسب شيئًا فشيئًا سلوكًا وَوَجهًا وصوتًا ويبدأ في مناجاتك. في الواقع، يشعر المرء دائمًا بِالذَّنب مع شخصياته. إنه يَهِبَهم الحياة، ويخرجون من عالَم الموت والغَيب، ويُوجدون فَجأةً ، ثم تقوم بِحَبسهم في قفص، وتُرغِمَهم على العَيش إلى الأبد في القصَّة التي ابتكرتها لَهم. وإن تَقصّ على القارئ كيف وُلدت شخصية ما، فذلك نوع من إهدائه تلك الشخصية، والقَول له: ها أنذا أُهديك هذه الشخصية، فَاجعل منها ما تشاء. وبوسْعِك أن تتصوَر لها قصِّة أو تاريخًا آخر.
الهوامش
(1) نَعت الأوساط الأدبية منذ سنوات قليلة رحيل الكاتب والروائي الإيطالي الكبير أنطونيو تابوكي، في وطنه الثاني البرتغال، في مدينة لشبونة.. بعد أن خلَّف وراءه أعمالًا عظيمة تستحق التقدير.. وبعد أن رُشِّح اسمه -مرارًا- لنيل جائزة نوبل في الآداب.
(2) أجرى الحوار الصحفي الفرنسي «ألكسي لييبارت، ونشره في العدد (486) من المجلة الفرنسية Le Magazine littéraire.
(3) نسبة إلى الزعيم السوفييتي بريجنيف.