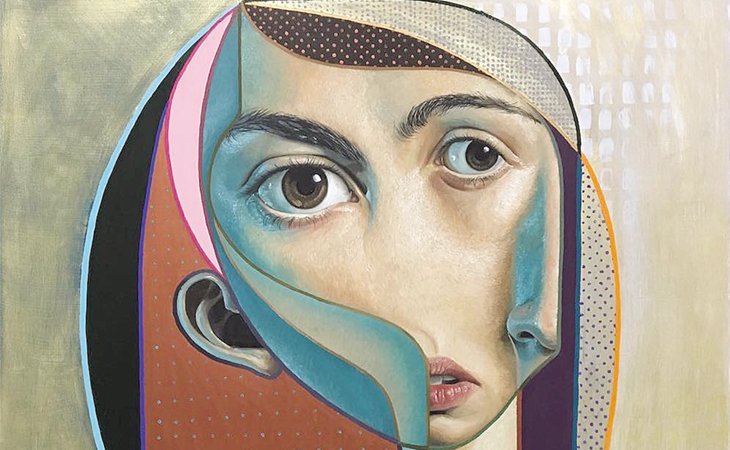أحمد المديني
1 – لا يستطيع أيّ كاتب/ كاتبة، في لبنان، أن يفلت من ربق أعوام الحرب الأهلية بما جرّته على البلاد من دمار وأهوال، ما كادت تتعافى منها إلا وعادت أشدَّ وأوْحشَ عيشًا ووقعًا. أسوأُ منه بالنسبة لهذا الكاتب، الروائي، وهو مواطنٌ إنسان، أولا، أن فظاعات الماضي تستمر في حاضره، ويتحول هذا بدوره إلى قطعة في فسيفساءِ خرابٍ يتناسل من سابق. لذلك، حين يقرر أن يقُصّ حكاياتِه المهولة، وما أكثرَها، تُثقِل على ذاكرته وتتماهى من طول ديمومتها وثبات فاعليها، فيحتاج إلى الفرز، فهذه مهمة الروائي، لأن الرواية انتخابُ الخاص من العام، وفي الوقت ذاته لا مناص له من جرِّ تركةٍ لصيقةٍ بكلِّ كائنٍ وشيءٍ وإحساسٍ وما تنفكّ تستفحِل، لذلك، يتداخل خاصُّها بعامِّها وهو ما يُملي على الكاتب/ الكاتبة نظامَ ونسقَ الرواية الشمولية.
2 ـ أحسب بهذا الفهم يمكن الشروعُ في قراءة الرواية الأخيرة لعلوية صبح “افرح يا قلبي” (دار الآداب، 2022)، وهي كاتبة ذاتُ تجربة متمكنة من فن الرواية، وممتحَنةٌ خاصة في صوغ أسلوبٍ يلائمها وميّزَها بحكيٍ مستقلٍّ في المتن الروائي اللبناني، المنغمس في واقعية قاهرة منذ اندلاع الحرب الداخلية (1975) وتتابُع ويلاتها إلى اليوم؛ تذهب إليها صُبح مرةً أخرى لتنبِش في أنقاضها فتنتشلَ جثثًا وبقايا أحياءٍ وتاريخًا مطمورًا وسبائكَ ثقافة وصفائحَ تقاليد متوارثة متوالياتِ أزمنةٍ وطوائفَ متآلفة غرقت في دم “الهويات المتقاتلة” لبلد “قطعة سما”. هكذا، تُعيد تشكيل هيكل مجتمعٍ وأجواء عيش تنبض بحيوات أجيال متعاقبة، تختار له هي نوع الرواية العائلية بالمعنى المدروس عند مارت روبير استيحاءً من فرويد، حيث تتوالى فرديات متصارعةٌ راغبةٌ في التميز لتكون الأفضل، وكذلك حيث العصب له امتدادات أبًا عن جد، وهذا ما تسرده الرواية في خط أفقي مع عائلة (أبو جمال) الدركي في بلدته (دار العز) الزوج المتسلط كما يليق بابن ضيعة مغوار، الطاغية في بيته، العصا لسانُه مع زوجته الصبور، المستهترُ في سلوكه إذ يعاشر سواها علنًا، والقامعُ لأبنائه، له كرسيّه في البيت، رمز سلطته، لا يجوز لأحد منهم أن يقتعده. هم جمال، محمود، سليم، عفيف، طارق وغسان، لكل منهم شخصيةٌ ومزاجٌ ومصير، هؤلاء، الأب، الأم، الأبناء، والأعمام والعمّات والجيران وآخرون يرسمون صورا متقابلة ومتنافرة وأصواتا متصاديةً وهجينة لمحيط واحد قانونه الغلبة وهيمنة الذكورية، واستعباد المرأة والأنوثة. تظل يدُ الأب هي العليا والأبناءُ يكبرون وهم ينفصلون، كلٌّ يأخذ طريقا: جمال البكر العاقل والمستنير يُقتل بسلاح أخيه عفيف الذي تطرّف دينيا بالانضمام إلى متشددين في الدين ظلاميين، علامة سقوط التسامح بين الأديان. سليم، تغلب هرمونات الأنوثة على ذكورته فيميل إلى المثلية عنوان شذوذ عار في بيئته. محمود يتزوج عشيقة أبيه برضاه فيقترف حراما. طارق، يهجر عائلته ليصبح مصورا دوليا تسحق نفسيته مشاهد الحروب ويخيب في زواج ظنّه ملاذه، وينتهي نادلا في باريس خير منقذ. وأخيرا، بل أولا، غسّان، واسطةُ العقد وبؤرةُ الحكي به تقود الكاتبة خيط السرد بدءًا ومنتهى.
3 – يمثل غسان مِقوَدَ عربة الرواية، إذ يستوطنه السارد شكلا، ومن روحه وحكايته ينتج معناه. لنعرض بإيجاز قصته: طفل رقيق ذو حساسية سمعية مفرطة في صباه تربطه بالأصوات، هي حاستُه الأولى والسادسة. يتعلم في بلده وينتقل إلى ألمانيا ليدرس الموسيقى ويصبح عازفًا شهيرًا للعُود والكمان، ومثل جلّ شباب لبنان إذ تسوء الأحوال يهاجر إلى أمريكا بنيّة إكمال الدراسة والتخصص، وفي نيويورك كما هي السيرةُ النمطية يتعرف على أمريكية إنما تكبره سنًا ويتزوجان ويعيشان طويلا في ثبات لكن بدون نبات. ذات زيارة لأهله في “دار العزّ” بعد أن مات الأب المتسلط، يلتقي بتدبير من أمه ببنت الحلال (رُلى) فيقع في غرامها وهو هكذا (صريع الغواني)، ويتزوج المرأة المسلمة سرًا عن كرستين الأمريكية (الكافرة) في نظر أهله، ينجب منها بنتا (آية) ويظل في ذهاب وإياب بين نيويورك والضّيعة، وفي كل زيارة يلاحظ التبدلَ الطارئَ على الوطن عُمرانًا وسياسة وسلوكًا كلُّه من سيئٍ إلى أسوأ، أبرزُه التشدُّدُ الديني لأخيه، يُحرِّم ويُحلّل كما يشاء، من آثار تطرّفه انقلابُ زوجته (رُلى) إلى متأسلمة متطرفة، وهجرةُ عائلات مسيحية خوفًا على حياتها، وبقاؤه موزعًا بين مضجعين إلى أن أنقذته رصاصة طائشة في فرح عابر(حلٌّ مصنوع للخروج من ورطة) قتلت زوجة على سنة الله ورسوله، ومواجهتُه لمأزق مصير ابنته، قرر أن يأخذها إلى وطنه الجديد ويعترف لكرستين المخدوعة، ما همّ النهاية المفتوحة، حيث غسان يهتز في مقعد بالطائرة يتوجّس سقوطها ضحية فانتازمات.
4 – بإمكاننا أن نسترسل في حكي مقاطع وعرض عديد مشاهد من محكياتِ روايةٍ طويلة كان بالإمكان طيُّ صفحات طوال منها، لأن الكاتبة حرصت من منطلق مفهوم الرواية الشاملة أن تقدم بإفاضة وتفصيل صورًا وأمثلةً لا حصر لها للمجتمع اللبناني، المسلم خاصة، من معتقداتٍ وعقليةٍ ومخيالٍ من منظور أنثروبولوجي، ومأكلٍ ومشرب ٍوملبسٍ، أضف وصف الطبيعة برًّا وبحرا، لونا ورائحة، ومع الوصف والأحداث القليلة، إذ الثبات والتكرار لازمة (لايت موتيف) ملحوظة كأنما الزمن واقفٌ وإن ذُكر تقريريا أنه يتغير، وقفات متكررة للتعليق السياسي والتأطير الفكري بضرب من الميتا خطاب؛ أقول، بوسعنا تقديم هذا وغيره من قصص طريفة عن تعدد الزيجات وعقلية الإقطاع، وصولا إلى عدّ آخر الانهيارات التي شهدها لبنان أصرّت الكاتبة على الإحاطة بها (انتفاضة الأرز، وانفجار المرفأ، إلخ..)، لا تريد أن يفوتها حدث أو خبر، أو لتجعل من عملها وثيقة أدبية تاريخية شاملة، بينما الأدب يستلهم التاريخ ولا يعوّضه، لكن غرضنا من هذه القراءة أهم وأبعد من عرض وحصر محكيات، كثيرٌ منها لا شك كشّافٌ ومشوِّقٌ ودالٌّ عن أوضاع بلد وأحوال شعب شقيَ في تاريخه الحديث بالاقتتال الأهلي والصراع الطائفي والسلطوي والمالي، باتت الرواية المجال الأوحد القابل لوصف شتاته وتمزقه، وبلاغتها الممكنة كما تنسجها اليد الحكواتية الصانعة لعلوية صبح، يا للمفارقة، مضمار وجود ودليل حياة، كما الرواية الفلسطينية تحتفي بإصرار بذاكرة المكان.
5 – غرضنا رصدُ الثيمات وضبطُ الأنساق وحصرُ مجموعة المفاهيم التي بُنِيَ عليها هذا النص وحدّد تَصوُّرَ كاتبته للمعاني المبثوثة فيه وما تُناصرُه وتشجُبُه من قيم، جلّه ينضوي في البعد الدلالي لرواية نرى أنها وقد كتبت على طروس سابقة هي تراث السرد التخييلي اللبناني، تطمح لتتقدم به وتنقله إلى أفق التفكير والسؤال المعرفي بأدوات ووسائط الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه ولو على حساب خسارات محتملة تصيب جسده الفني بالرضوض، تتعرض لها الرواية الثقافية التي أعتبر “افرح يا قلبي” نموذجا لها. إنها تعالج تيمات محددة: التقاليد المحافظة، الهيمنة الذكورية، التعايش الطائفي، التطرف الديني، أزمة الهوية، صراع الحضارات، الأنا والآخر. هذه التيمات وما يتفرّع عنها موجودةٌ بوصفها حالاتٍ وتمثلّات، وباعتبارها قوانين داخلية، أي أنساقًا تنظم العلاقات داخل المجتمع وتتسيّد بنيةً عليا بالمصطلح الماركسي فوق بنية تحتية. فالأب (أبو جمال) شخصيةٌ روائيةٌ ضمن قالبٍ، نمطٍ سلاليّ اجتماعي للرجل في المجتمع الشرقي، كلمتُه هي العليا، وتتجسدُ سلطتُه في ممارساتٍ وقوانين معلنة ومضمرة، منها المستمدُّ من الدين: تعدّد الزوجات، كما شخصية محي الدين، بزعم رفض الزنا (الذي يقترفه أبو جمال) فلا يكف يتزوج ويطلق ليبني بأخرى في حدود ما يبيحه الشرع؛ ومنها سلطة العُرف، أن تتفانى المرأة في خدمة الزوج، وتُضرب وتبلعُ الهوان. الابن عفيف، تمثيل لنموذج التطرف والتأويل الأعمى للدين (الإسلام) شوّهه وسوّغ أساليب َهمجية ضد مبدأ الحياة، وتصل إلى جواز قتل الأخ لأخيه، بتحريض من دوغما دخيلة تحولت نسقا بانيًا لفرض أحكام وشعائر.
6 – الأهم، بين التيمات والمفاهيم والأنساق، المتحرك منها يدور حول الهوية، باعتبارها مفهوما متململا بين الثبات والتحول، القداسة والإباحة، الأصيل والمتغيّر، وبوصفها مصطلحا إشكاليا قابلًا لتصريفه دراميًا، ما مثّل أو ينبغي أن يمثل مادةَ ومضمارَ الصراع على امتداد القسم الأكبر من الرواية، مسار غسان همومًا وأفكارًا وتوتراتٍ وماجريات تخصه وعلاقاته هي تجسيده سيتأسس شخصيةً نمطيةً في الرواية العربية منذ “قنديل أم هاشم” (يحيى حقي، 1940) وعبورًا بـ”موسم الهجرة إلى الشمال” (الطيب صالح، 1966) و”المرأة والوردة” (محمد زفزاف، 1972)، انتهاءً بـ”خارج المكان” (ادوارد سعيد، 1999) على سبيل المثال لا الحصر.
7ـ سرديًا، يأخذ محكيُّ غسان القسمَ الأوفرَ من الرواية، وهو محورُها منبعًا ومصبًّا، تتفرّع عنه غدرانُ ومساربُ تفيض عن الحاجة، حتى لبإمكاننا أن نستغنيَ عن جميع الشخصيات ونكتفيَ منها بإشارات ليبقى هو السيد وبؤرةُ السرد وموضوعُ المسرود، وكم سنتعلق به في البداية، نتتبع رسم شخصيته وتبلورَ أحاسيسه وخصوصًا نسغَه الصوتي، فالحيُّ والجامدُ عنده صوتٌ يسمعه والرائحة والصورة كذلك، هو صديق الأصوات ولها عنده ملمسُ الحرير والمخمل “كان إذا تكلم معه أحد يشعر أنه يراه بأذنيه”(ص38) فكبُر لسانُه وعشقُه الغناء وتعلّمَ الموسيقى، وعزفُ العود عنده عبادة، إلى أن امتهنه وغدا مؤلفا مشهورا. منه تتدفق الأغاني”افرح يا قلبي” لأم كلثوم، وسواها كثير بمناسبة وغيرها، ويمكن أن ندوّن ألبوما من الأغاني أحصيت منها ثلاثين على الأقل، يشدو بها وأهله متضمنةً بمناسبة وبدون، هي الماءُ الرقراق يسقي جفافَ الروح، والترياقُ لقحط وغلظة النفوس، كأبيه الجلف المتسلط، “كان لدى أبيه 622 تسجيلا لحفلات أم كلثوم و27 تسجيلا لأغنية يا ظالمني”(ص75).
8 – المغنَى في هذه الرواية متنٌ إضافيٌّ مُدمجٌ في قرصها ومكوّنٌ أساسٌ لدلالاتها في مرحلة تاريخية زاهرة وناهضة للشرق العربي (المرحلة الناصرية) الأغاني العاطفية تعبيرٌ عنها وحبُّ مصرَ الجارفُ والشدوُ بها حنينٌ إليها مقارنةً بانحطاط الحاضر في “دار العزّ” اللبنانية التي كانت. إحلالٌ واستحضارٌ مكثفٌ لمشرق أمس عند جيل في طريقه إلى الزوال، تستعيده علوية بنوستالجيا النغم تتحقق بخطاب الـ(Melody) في وصلات متقطعة يضمها (كشكول) أغانٍ يمكن تعيين تيمتها من المركب المعجمي لعناوينها موزعة بين أشهر المغنين العرب المبتلين بالحب وعذابه: أم كلثوم، محمد عبد الوهاب، عبد الحليم حافظ، فريد الأطرش، فيروز: ( ليه يا بنفسج؛ يا ظالمني؛ الهوى غلاب؛ جّددت حبك ليه؛ القلب يعشق كل جميل…) وكوكب الشرق في قلب الجوقة معبودةُ الأب لا تفوته سهرةُ الخميس القاهرية، ولازمة أغنية (افرح يا قلبي) هي التيمة المركزية في سيمفونية الشجن مسموعة ومهموسة. يضاف إلى الغناء الخطابُ الديني بتضمين الآيات القرآنية والحديث في حجاجٍ عقيدي دفاعًا عن الإسلام المعتدل في وجه المتشدد وبمطارحاتٍ تُثقل كاهلَ النص، وصادرةٍ على لسان الكاتبة مناظرةً يتكرر في غير موقف وينتأ نشازًا يضخِّم الميتاـ خطاب في الرواية، المحكوم بضوابطَ أولُها أن يولد أصلا لا مقحما. لكنه شاغلُ صنع الرواية الثقافية يورّط أحيانا في تعبئتها في لفائف نظرية ولغاتٍ سجالية، وهذه تقدم لنا الصراعَ الذهنيّ والتمزقَ النفسيَّ لشخصية غسّان في تقاطع أزمة الهوية وشرق غرب.
9 – تنقسم “افرح يا قلبي” إلى قسمين بما أنها تنتقل بين بلدين وفضاءين وثقافتين: لبنان/ البلدة، لا تحديد لها جغرافيًا، يُكتفى بتسميتها دار العز؛ وأمريكا/ نيويورك. قرارُ الهجرة عند بطلها فجائيٌّ وغيرُ مقنع رغم أسبابه الموضوعية العامة، وتبعاته كذلك، أقواها نبذُ كل ما يَمُتّ إلى الشرق بصلة برمز القطيعة مع آلة العود، للارتماء كليًا في أحضان الغرب (الأمريكي) ومعانقته ثقافيًا مطلقًا برمز عزف الموسيقى الغربية والاستماع إليها حصرا؛ ثم وجدانيًا بالاقتران بأمريكية وحبّها بإخلاص. ما لا يحسم الصراع في نفسه بل يحمي وطيسَ الفصام والازدواجية في شخصيته، يتحسّسها القارئ من خلال مونولوجات داخلية ومناجاة وتوترات لفظية أكثر منها أفعالًا، الأفعال قليلة إجمالا ما يفسح المجال للمناظرة والسّجال حول مفهوم الهوية بإيراد التعليقات والاستشهادات وتصورات البطولة بين شرق وغرب (ط. صالح، إ. سعيد) ووضع الأطروحة ونقيضها، وهلُمّ. بين مشاعر الاجتثات ونبذ الوطن الأم وإعلان القطيعة معه، والرغبة المحمومة في الاندماج في القارة الجديدة رمزها جسد كرستين، مع معاناة عقدة مصطفى سعيد (ط. صالح) ومواجهة الاختلاف الثقافي والتوزع بين وطنين- جسدين، ثقافتين، كرستين ورُلى، عزف عود وجاز، يجترّ غسان سؤال انفصام الهوية ويغرق فيه بلا أفق للجواب بما أنه إشكالية، تقدمها علوية صبح بصيَغٍ نظرية وتهويمات وخاطرات شعرية ولا نراها تعاش، قد غلب النمطُ المسبقُ والنّسق الناظمُ له على شخصية روائية وضعها المطلوب أن تحيا في فعل وبإيقاع درامي من نبض الواقع لا بالمفهوم وأسبقية النمط لتحشى بالمعنى.
10 – هذا منطق الرواية الثقافية ولا أسمّيها رواية الأطروحة، لأنها أشملُ، تنضوي بداخلها عوالمُ وخلائقُ بمروياتٍ ومصائرَ شتى، لذلك تكثرُ فيها الحكاياتُ بسجلاتٍ لغوية متعددة، الشفويّ أحدُها، رنّان، والأشجانُ والآهات، بين أحياءٍ ذهبوا ومثلُهم كالأموات، كأنما الزمن حلقة مفرغة وهي تعضّ ذيلها مطروحة على صعيد طرح إشكالي أقوى من منسوب التخييل، وهذا أيضا اختيار. ليس لنا أن نحكم له أو عليه، فقد قررت علوية صبح من البداية وضع سارد عليم سلّمته زمام الحكي والقول ووضعت في عُهدته مسارَ القصة ومصيرَ الشخصيات، بل وليفكرَ نيابةً عنها وتتلجلج في(نفسه) الخواطر، فكأن الكاتب من ورائه من يقرر ويتكلم فتتقلّصُ المسافةُ بين الواقع والتخييل، الأول هو الفكرة والعبرة (النوع الخبري) الكلاسيكي عند العرب، والثاني نوع الرواية، لدى الغرب، وهو ما يسعى إليه جميع الكاتبات والكتاب العرب من صناع الرواية بوعي لا يكف يتولدُ عندهم منذ “زينب” هيكل، ومرورا بأبيها عربيًا نجيب محفوظ وامتدادًا عند مرسّخي الواقعية، وصولا إلى آخر التجارب الحديثة والتجريبية، أيضا. لكي يرسخَ أيُّ فنٍ يحتاج إلى الاستقرار، وهو غير الجمود، عندما تُبنى قواعدُه وتَصعد أعمدتُه وتتمظهر معالمُه، ويصبح ممكنا السيرُ في نهجه وفق أسسٍ وقد اكتسب هويةً محددةً ومتحولةً في وقت. أرى أن هذه الهوية الأخرى هي ما تواصل الرواية العربية البحث عنه من خلال تمثيلات ونماذج أغلبها تمارين على تراث الرواية الغربية والأجنبية عامة، وحين تتملّكها وتعود تتخلّق بملء قدراتها، يمكن القولُ إنها أخيرًا حازتها لتنتقل إلى تجديد خلاق لا شعاري. إن مساءلة علوية صبح للهوية ينبغي أن يوضع في إطار شمولي أحسب أن استخدامها للرواية مع وفرة الخطابات والصياغات والسجلات واللغات المبثوثة والمستخدمة عملية كلية، إذا فهمنا أنها مركّبةٌ من طرفين: مساءلة الهوية من منطلق وعي نظري، وتشخيص إشكاليتها بتركيب فني، أيُّ رهان!