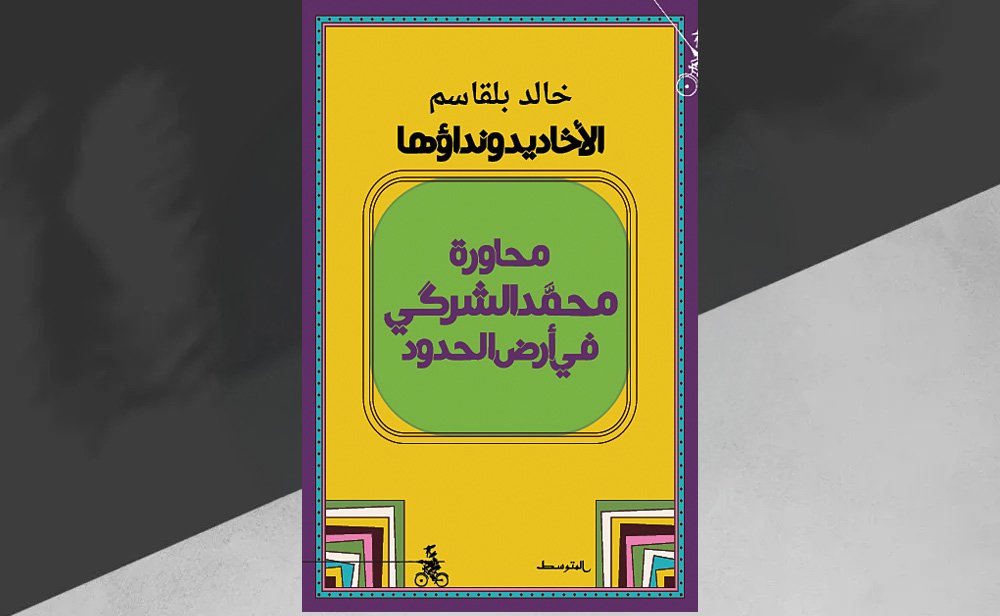محمد ودغيري
باحث مغربي
ليست الكتابة مجرّد عمل فرديّ يستقيمُ تحقّقه بصيغة واحدة، بل هي، إلى جانب ذلك، فعلٌ مُتعدّد في وحدته ومُنفتحٌ على صِيَغ تُمدِّدُ تَصوّرَه. من هذه الصيَغ، تَحقُّقُ الكتابة بوصفها مُحاورةً تسعى إلى إضاءة المعنى بصورة بَينيّة، وإلى إقامةِ جسور تجعلُ الفكرَ يتخلّقُ في الاختلاف وبالاختلاف، بما يُمكّنُ المعرفة المُتوَلِّدة بالحوار من الإسهام في تقريب الإنسان من نفسه ومن آخره، هذا الآخر الذي ليس سوى الذات وهي تتأمّلُ نفسَها في فعل المُغايرة/ المُغامرة.
على أرضية هذا الوعي وفي ضوئه، يندرجُ عمل خالد بلقاسم وهو يَستدعي محمد الشركي(1) إلى حوار في “أرض الحدود” من خلال الكتاب الذي اختير لهُ عنوان “الأخاديد ونداؤها، محاورة محمد الشركي في أرض الحُدود”، الصادر عن منشورات دار المتوسط – إيطاليا، ط1، 2025.
1. الحوار أفقا للشعر والنثر
في مشهد ثقافيّ مغربيّ وعربيّ اعتادَ فيه الباحث أن يُنصتَ إلى نفسه، مُعطّلا صوتَ الآخر فيه، مُنتصرا، بشكل يكاد يكون مرَضيّا، إلى ما يُسمّى المشروع الفكريّ(2) أو الشعريّ الخاصّ، يجترح خالد بلقاسم سبيل المُغايرة، مُستدعيا تجربةً متميّزةً في الفعل الإبداعيّ إلى فضيلة الحوار(3). ليس الحوار كما درَجت عليه الكتابة الصحفيّة العجلى، بل بما هو محاولة ثانية للكتابة وإعادة الكتابة، وبما هو تشييد للمعنى بين رُؤيتيْن؛ رؤية الكاتب، ورؤية القارئ الكاتب. تحقّقَ هذا التصوّر للفعل الكتابيّ في حوار سابق مع الأديب المغربيّ عبدالفتاح كيليطو، وهو الحوار الذي جسّده كتاب “تجويفات”. في هذا الكتاب، انبنى المعنى اعتمادا على لقاءٍ بين ثلاثة أصوات: كيليطو وخالد بلقاسم ومحسن عتيقي. وفيه عمِلتْ الأصوات الثلاثة على تأوّل المنجَز النقديّ والإبداعيّ لعبدالفتاح كيليطو من مداخل لا تتأتّى إلّا لمَن أقام طويلا في تجاويف هذا المُنجَز، وتزوّد بما يكفي من معارف وخبرات في تفكيك النّصوص والحفر في طيّاتها. لقد كان الحوار في “تجويفات” يُجدّد النظر إلى القضايا التي يُقاربها، ويستدرجُ كيليطو لأن يَقرأ مُنجَزَهُ في ضوء الأمكنة التأويليّة التي يعتمدُها الحوار.
في كتاب “تجويفات”، تشكلت البذرة الأولى لهذا التوجّه الذي يرومُ استنبات صيغة كتابيّة في المشهد الثقافيّ المغربيّ والعربيّ، باستعادة الحوار من إرهاق الاختطاف الذي تعرّضَ له، ومن الاختزال الذي أفقدهُ وهجَهُ الفكريّ. إنّها استعادة تسعى إلى تحرير الحوار من غيبة فُرضت عليه قسرا في ثقافة تنتصر للواحد صوتا وصنما، وإلى تخليصه من الاستسهال، ومن السيولة التي زحفتْ على كل شيء في عالم أرخى فيه “إله الابتذال” بظلاله على المعنى. تحققت هذه الاستعادة في الكتابيْن: “تجويفات” و”الأخاديد ونداؤها” بالحرص على فَصْل أسئلة الحوار عن التّعميم، الذي يُفرغ مفهوم المحاورة من حمولته المعرفية(4)، وبتمكينه من تلافي كل نزوع إلى الابتذال والاستسهال المُجسّديْن في الصيغ جاهزةً التي صار “الحوار” ضحيّةً لها”. صيغ صارت، من فرط التّكرار والتعميم، شبيهة بمسكوكات وكليشيهات، تتوجّه إلى المحاوَرين جميعهم من دون أن تعني أيّ واحد منهم، ومن دون أن تتطلب أي جهد، على نحو غدا فيه “الحوار” حاجبا لا للتجارب الكتابية فحسب، بل لفعل المحاورة نفسه، بتجريده من بعده المعرفي، ومن انشغاله الرئيس باستجلاء الاختلاف بين تجارب الكتّاب”(5).
لم تكن تجربة الحوار مع كيليطو إلا إعلاما بوعي كتابي جديد، يروم البحث في التجاويف والأخاديد، اشتغالا على أصوات إبداعية متميزة، لا يلفتها الضوء وبريقه العابر. أصوات تعي ثقل الكلمة ومسؤوليّة الكتابة بما هي التزام بالكتابة أولا وبمقتضياتها، بعيدا عن أيّ بهرجة تتغلف بـ “الالتزام” الذي ابتُذل حتى ما عاد يعني شيئا. أصوات تقيم في العتمة وفي مناطق الالتباس بكل ما تنطوي عليه من إغراء.
لقد كان الحوار مع محمد الشركي أو المحاورة كما سمّاها عنوان الكتاب تأكيدا لهذا المنحى في انشغاله بترسيخ صيغة المفاعلة، بما هي مشاركة في الكتابة وفي تحمّل مسؤولية معنى يتأبّى على العصبة أولي القوة من المتأوّلة البارعين، فضلا عن كونها تأكيدا لوعي جديد يؤمن بالتعدّد وبالكتابة لا بيَد واحدة بل بيدَين أو أكثر.
2. المحاورة في أرض الحدود والكتابة بيدَين
تحاول تجربة الكتابة/ الحوار، وصْل ما انقطع في ثقافتنا العربيّة الحديثة. إنها تجربةٌ تتصادى، بمعنى مّا، مع تجارب كتابيّة راهنت على الحوار سبيلا للفكر والتفكر، من نماذج هذه التجارب، ثمّة، تمثيلًا لا حصرًا، مراسلاتُ الخطيبي وجاك حسون، نقاشات الجابري وحسن حنفي في حوار المشرق والمغرب. غير أنّ ما يُميز تجربة بلقاسم هو أنها تنأى بالحوار عن السّجال، كما أنها تجعل الكتابة/ الحوار شكلا من أشكال تقليب النظر في النّصوص فهما وتأويلا، أي إنها تجعلُ الحوار آلية لتوليد المعنى واستشكاله. فالحوار، على عكس الكتابة الأولى، ينطلقُ من النص، مُسترشدا بمَبدأ التعاون على إضاءته من خلال حوار ينتصرُ للفهم المُتخلّق من داخل السؤال بما هو بحث، والبحث، أساسا، هو “بحث عن الجذور. إنّه الاستقصاء والغوص حتى الأعماق والحفر في الأسُس وتقصّي الأصول”.(6) يتعلّقُ الأمرُ إذن بحوار يؤسّس لاختلافه بالمسافة/ الصمت التي تفصل بين صَوت بلقاسم والشركي وهُما يتناوبان على بناء المعنى في الكتاب، ذهابا وجيئة في جغرافيا منجَز إبداعي يتضايف فيه الشعر والنثر داخل فضاء كتابة تنحاز إلى التّخوم والأقاصي والأغوار، أي تنحازُ إلى مناطق نائية لتوليد رؤى ومعان مُغايرة؛ توليدها من داخل السّموّ اللغويّ الذي بلغتهُ العبارةُ في أعمال محمد الشركي الثلاثة: “العشاء السفلي”، “كهف سهوار ودمها”، ثم “السراديب”.
يتناول الحوار/ الكتاب، وهو ينصت لنداء الأخاديد، فكرة “العود الأبديّ” و”التجربة الحدودية”، و”الكتابة الغورية” و”الطيّ الكتابي”، و”الغامض في الكينونة”، و”الحبّ على عتبة الموت”، وغيرها من القضايا الكتابية المستمدّة من تجربة محمد الشركي الكتابية”(7). إن هذه القضايا تُشكّلُ، في الآن نفسه، الأمكنة التي فيها تُنجَزُ المحاوَرة، كما لو أنّ هذه الأمكنةَ مساحاتٌ في أرض الحُدود.
1.2. الكتابة من رحم جغرافيا الروح
في مقدمة الكتاب/ المحاورة، يكشف خالد بلقاسم عن النسَب الفكريّ الذي إليه تعود كتابة محمد الشركي، خاصة روايته “العشاء السفلي”. إنه نسبٌ إلى الموت في حمولاته العرفانية. فقد رامتْ هذه الرواية كتابة الشهوة على عتبة الموت، مُنتسبَةً بذلك إلى أرض الحدود، ودافعة باللغة إلى مجاهيلها القصوى، مُحمّلة إياها مسؤولية قول ما لا ينقال.
من هذه الرؤية/ الرؤيا التي تحصلت لمحمد الشركي تولّد نصّ “العشاء السفلي”، مراهنا “على القوّة التي يمكن أن تضطلع بها لغة الأدب في استلام الودائع الروحية، وفي الائتمان على الأسرار العليا، وفي استجلاء الاختبارات الحدوديّة، وفي التقاط وميض معنى غائر على شفا الموت”(8). إنها كتابة متأتية، في سياق ما راهنت عليه، من خلق لغة وتركيب ينهضان على وعي مفارق لا يتنكر لأساسه الحسي، الواقعي والمعيش. فشأنها شأن كل تجربة راهنت على الأقاصي/ الأغوار في بعدها الروحي. لذلك كان لابد لهذه التجربة أن تأخذ الكتابة إلى أفق شعريّ حتى حين تنخرط في تضفير موضوع سرديّ كما هي حال اللغة في نص “العشاء السفلي”. إنّها لغة تنهض بوظيفة استشكال الوظيفي والعابر في نزوعهما إلى اختزال كينونة الإنسان ودفعه إلى نسيانها. هذا الاختزال هو ما تسعى الكتابة إلى أن تحول دونه، بالعمل على استعادة المنسي من الوجود، أو الوجود المنسي بعبارة هايدجر. إنه الوعي الذي يحمله محمد الشركي إلى الكتابة بعد معايشته وجوديا في تجربة تحتفي بالمعنى، ملقية بكل ما يعرقل حركيته. فرهان الكتابة إذن هو حماية وجودنا مما يتهدّده من إسفاف وزيف ينتصر إلى المألوف والبدهي، ويستثمر في الحسي حريصا على تأبيده وتبليده. وهي حماية مشروطة “دائما بالاستئناف وبعدم الركون إلى أي اطمئنان خادع، لأنّ منظومات هذه البلاهات- البداهات دائمة التناسل والانتشار مسنودة بكلّ الترسانات الجبارة التي وضعتها الأنساق السياسية ولوبيات المال ومبتكرات التكنولوجيا في أياديها المرعبة”(9).
هي، إذًا، معركة ضد الانسياق إلى الجموع البلهاء، تبغي الأنس بالذات وهي تراود عزلة مأهولة بأقباسها الروحية، مُوَلّدةً كتابةً ممانعة ومقاومة لكلّ تسطيح، إذ ما “من كتابة مُمكنة من دون التعاقد مع العزلة وقبول امتحاناتها، مثلما يقبل المستكشفون اختبارات التضاريس الوعرة الغامضة خلال بحثهم عن منافذ المناجم”(10).
هل تكون الكتابة ممكنة، بهذه الأبعاد التي تتجلى في المنجَز الإبداعي لمحمد الشركي، من دون هذه الخلوة وما يتحقق في رحابها من صفاء يمكّن الروح من معانقة أقاصيها؟ أتكونُ ممكنةً من دون هذه العزلة وما تهيئه للنفس من فيوضات تصون كينونة الإنسان من الصدأ والابتذال الذي يغلّف حياة الناس؟
الجواب حتما بالنفي، فقد كانت الخلوة محبّبة إلى النفوس التي تاقت إلى الهبات العلوية، النفوس التي تتشوف إلى أن تشرق المعرفة على صفحات القلوب والأرواح مثلما نجد عند أرباب الأذواق الذين تقتسم معهم كتابةُ الشركي بعضا من أحياز المعنى.
لا مناص، إذًا، يؤكد الشركي، “لتأمين أحياز الروحي وصونها من مكائد اليومي أو إغراءاته الاحتيالية من تجذير العزلة كميثاق فكري ووجداني غير متعال على الواقع، ميثاق متورط في هذا الواقع وفي الوقت نفسه غير منخدع بثبات أمانه السطحي، ميثاق سميع للجرح الداخلي وغير مفرط في رسائله، وسعيد بالأغنية البعيدة التي لا تنفك تقول لمن يصغي إليها بجوارح الداخل، من خلال كل ما يراه من تفاصيل “أنا هنا”(11).
2.2. من ضيق الثنائيات إلى رحابة الوعي الروحي
تستند القراءة/ المحاوَرة في هذا المدخل التأويلي إلى التحييز الأول لكتابة تنأى بنفسها إلى الداخل دون أن تتنكر لخارجه، كتابة تسترفد مدلولاتها من الأغوار في كل أبعادها الروحية النزّاعة إلى التحرّر ممّا يقيّد المعنى الإنساني ويعطل تجربة الكينونة. بنفَس صوفي وفكري تتهدّم هذه الحدود الحاجبة ليعاد تشكيلها وفق رؤيا تنزاح عن المقاييس والأبعاد الحسية بين مفاهيم القرب والبعد، العلو والسفل، الصعود والهبوط، وقد اخترقتها معان جديدة لا تركن لمبدَأي الهوية والتناقض، فهما مبدآن حاجبان وفق هذه الرؤيا.
إن الاشتغال بهذا الوعي في الإنصات لِمنجَز محمد الشركي، يقتضي حسب هذا التأويل واستنادا إلى موجّهاته نسيانَ ما رسّخه النظر الحسّي إلى الأشياء في ثباتها وصفائها الحاجب، والانتقالَ إلى تناول الأشياء باعتبارها مسرحا لسريان الوحدة، حيث المعنى وضدّه، بما هو كينونة يتولد بعضُها من بعض وينتسب بعضها إلى بعض، في تواشج يكشف عن حقيقتها الروحية ونسَبها إلى أحيازها.
بردم الهوة بين الأضداد، تستقيم الكتابة/ القراءة في منجز محمد الشركي، كما يؤكد هو نفسه في المحاوَرة، إذ الثنائيات بحسبانه هي “دوكسا” الاستقرار السطحيّ، و”حارسة الآفاق المرعية، وهي الفيصل بين المعلوم والمجهول والصالح والطالح، والواضح والغامض والمباح والمحظور. لذلك يكون التصدّي لتقويضها معادلا لزعزعة سنائد المجال العموميّ والنسق الذهني الساري في أوصاله”(12). هو إذا نسق جديد ترومهُ الكتابة الروحية، نسق ينفر من المواضعات، ويميل إلى الاستشكال ومعاودة السؤال بما يفكك، بل ويهدم تلك الأوهام التي تتبدى للحسّ في شكل حقائق.
3.2. مقاومة الكتابة لما يتهدّد حقيقتها
تأخذ المقاومة في سياق القراءة/ التأويل مدلولات تنأى بها عن المألوف والبدهي باعتبارهما تشويشا على ما ترومه الكتابة المتولدة من أحياز الروح. فليست المقاومة في الكتابة مرادفا للنضال والالتزام أو الانخراط مثلما ابتذلته شعرية النّضال والمقاومة في انتصار لمنظور براني، يرى المقاومة استبسالا في وجه ما يتهدّد الأنا من هُناك، بل المقصود بالمقاومة كما تحاول المحاورة تبيانه وبناءه، هو ما يأتي من صُلب الكتابة نفسها وهي تجابه كل ما يتهدّد حقيقتها ونسبها الروحي من إسفاف وابتذال، أصبحا شرط وجود في عالم ابتذل كلّ شيء بما في ذلك المعنى.
ما الذي يمكن للكتابة أن تقاومه؟ ما المقاومة في الكتابة وبالكتابة ؟ وما معنى أن تكون الكتابة مقاومة؟ وكيف تتأتى المقاومة في الكتابة وبها؟ ألا يتطلب الحديث عن المقاومة في الكتابة التفكير فيها من داخل هوية الفعل الكتابي، بما يضمن لهذه الهوية تميزها عن الكلام؟
هي ذي الأسئلة التي تجتذبها المحاوَرة/ القراءة إلى ليل التأويل، في محاولة لاستجلاء ما به تبني الكتابة معنى المقاومة بعيدا عن كلّ الدلالات التي استهلَكت هذا المفهوم، إذ “ما من كتابة جديرة باسمها ومعناها من دون اصطفاف مقاوم إلى جانب العمق الذي يتمّ الآن تسطيحه والجرح الذي يتم ابتذاله والجمال الذي يتم تسليعه، والكرامة التي يتم تركيعها والأقليات التي يتم تذويبها، والشعوب التي يتمّ التلاعب بها، والذاكرات التي يتمّ محوها، واللغة التي تتم مماهاتها بحضيض السوقية”(13).
إن مهمة المقاومة بالأساس هي استعادة اللغة وتحريرها من التسطيح الذي يطولها اليوم، في سياق هيمنة منطق التسليع والاختزال. من الضروري والحال هذه معاودة النظر فيما يجب أن تتوجّه إليه المقاومة بالكتابة. وهو ما حرص على توضيحه محمد الشركي، بناء على التأويل الذي بلوره بلقاسم، مُحدّدا الجبهات التي ينبغي أن تتوجّه إليها هذه المقاومة:
– مقاومة الكتابة على جبهة اللغة، بالاشتغال على اللغة في ذاتها وتحرير الكتابة من الكلام الذي يلتبس بها، والتصدي للسّطو الذي يتم على معجمها ومفاهيمها؛
– مقاومة على جبهة الفكر، بفتح اللغة على روافد المعرفة الدائمة، وعلى ما يمكن أن تغتني به مما توفّره حقول المعرفة الأخرى.
– مقاومة بالكتابة على جبهة السياسة، بالاصطفاف العميق واللامشروط إلى جانب القوى الكابحة للاستبداد والفاعلة ضد الظلم والتفقير والتجهيل ولجم حرية التعبير.
– مقاومة على جبهة الذاكرة، بفتح الكتابة على التراث كله بمختلف أبعاده وأنواعه، المحلّيّ والكونيّ.
– مقاومة على جبهة النسَب الرمزيّ بإعادة النظر في أشجار النسَب الموروثة فرديا وجماعيا، بتشذيبها وغرس أخرى جديدة تتكوّن من أكبر عدد ممكن من الأرواح الكبيرة الفاعلة قديما وحديثا في الحركية الروحية والرمزية للعالم.
– مقاومة على جبهة الجيو بويطيقا، وذلك بانخراط الكتابة في جماليات التفاصيل الأرضية باعتبارها- أي الكتابة، إقامة شعرية في العالم وجزئياته اليومية(14).
هي جبهات تكشف، كيف أن الكتابة تنخرطُ، وهي تنتصر لما يحفظها ويبقيها بعيدة عما يتهدد “روحها”، في رسم علائق جديدة، بما يمكّنها من أن تسهم في تحصين، أو إعادة تحصين ما يتهدّد كينونة الإنسان، سواء أكان التهديد ناتجا عن ابتعاد الكتابة عما به تغتني لغة وفكرا ومعرفة أو كان التهديد آتيا من نزوعات سياسية أو أيديولوجية تستهدف الإنسان في حقيقته، وفي حريته، بما هي شرط وجوده، وفي انفتاحه وتعدده باعتبارهما شرط الخلاص من النزوع الهوياتي المنغلق، فالهويات قاتلة كذلك.
4.2. اللغة والإقامة في التخوم
لا تنفصل تجربة الكتابة عن تجريب اللغة، فالأخيرة ليست مجرد أوعية فارغة تنهض بعبء حمل معان برانية عنها. إنّ كل كتابة تنتسب إلى أحياز الروحي هي بالضرورة تجربة اشتغال باللغة، حيث تضيق العبارات بالمعاني المتولدة من رحم هذا الأفق، ما يحوج الكتابة إلى خلق لغة تستند إلى الرمز والإشارة. فالعبارة حاجب و”كلما اتسعت الرؤية ضاقت العبارة” يُعلمنا النفري(15).
يتحتّمُ على اللغة، في هذا الأفق الغوري، أن تنأى بنفسها عن الوظيفي وتنخرط في استشكال الوجود، لا بغرض إيضاحه، بل بإضفاء مزيد من الالتباس عليه. الالتباس بما هو حقيقة كل معنى أو حقيقة تنتسب إلى أحياز جغرافيا الروح. وهو أمر تحقّق حسب بلقاسم في المنجَز الإبداعي لمحمد الشركي منذ عمله الأول “العشاء السّفلي”، إذ فيه تبدّت اللغة حبيبة رمزية كبرى بعبارة محمد الشركي. يقول:
صارت اللغة سيدة مرتاعة
تنتظر في شرفات المعنى
عودة الكلمات من مفرها
إلى القفار السحيقة
والأدعياء يطوفون حول سورها الرباني
يلتقطون فتات سهرتها
وهي الملكة والبغي المقدّسة
تصعد وتنزل بين الأعالي والحضيض
دمها أبعد من صفقة القتلة
وجسدها شهوة عميقة.(16)
5.2. الكتابة بإيقاظ الموتى
تسترشد القراءة/ المحاورة في تأوّلها لهذا الفعل الكتابي في أبعاده السردية بمفهوم فكري دولوزي (نسبة إلى الفيلسوف الفرنسي جيل دولوز)، هو مفهوم الطي باعتباره سمة مميّزة لفعل الكتابة تمتد إلى ما تنطوي عليه القراءة من رغبة في الكشف وهي تنقّب في طيات/ طبقات المعنى. الطي سمة ميّزت كتابة محمد الشركي حسب خالد بقاسم منذ أن كشفت عن نسَبها إلى الاستغوار وإلى الأحياز الروحية لتتعدّد بذلك الطيات كما في العشاء السفلي. أبرزها طية الموت التي عملت القراءة على تمديدها في المحاورة استنادا إلى ما تحقّق من تجلياتها في النص نفسه، حيث الحوار في عرصة ميزار بين مغران وعدد من الأموات يستعيدُ معهم عوالم وتجارب ماضية، تذكر في نوع من التصادي بنصوص مركزيّة في سحيق الثقافات الإنسانيّة.
إن الكتابة عن الموت ليست مجرّد ميسم جَمالي وحسب، بل هي من صميم الوعي الحافز على الكتابة في تجربة الشركي، إذ لا يستقيم المعنى ولا يأخذ حقيقته إلّا إذا كان مهدّدا بالفقد/ بالموت، وهو أمر عايش محمد الشركي حقيقته وهو طفل صغير في تجربة اقتراب من الموت، أو عودة منه بحسب الكيفية التي يُمكن بها للقراءة أن تتأوّل الحدث. يقول بناء على هذه التجربة، “ظللت طوال العقود التي عشتها أعتبر حياتي هبة من الموت، وأنها وفق قانون الهبة امتداد للموت واهبها، وأنني مَهما توغلت في زمن الحياة أظلّ منتسبا إلى مجهول ما قبلها وإلى مجهول ما بعدها”(17).
6.2. الاستئناف والعود الأبديّ
تنتقل المحاورة/ القراءة في مُساءلة “العود الأبديّ” إلى العمل الثاني في منجَز محمد الشركي، أي إلى ديوان “كهف سهوار ودمها”، الذي جسّد استئنافا لِمَا انطوى عليه العمل الأول “العشاء السفلي”.
يكشف خالد بلقاسم عن هذا النسَب الذي يربط العمليْن، وذلك بالحفر في دالّ “السهر” في اسم “سهوار” وفي الحدّ الثاني للاسم، أي دالّ “وهبي”. لقد اضطلع الدالّ الأوّل بفعل تسمية مضاعَفة، إذ تحول إلى دالّ من دوال عنوان الكتاب الثاني بعد “العشاء السفلي” وإلى اسم امرأة (سهوار) في الآن ذاته، “المرأة التي حملت في شرايينها دم ميزار أي واهبة الموت في “العشاء السفلي”(18). دمٌ استمرّ جريانه في نصوص محمد الشركي، بما يؤكّد انتسابها إلى الأغوار وإلى زمن دائري أسطوريّ لا يفتأ يعود باستمرار.
لقد كان لمفهوم العود الأبديّ(19)، باعتباره مفهوما نيتشويا، دورُه في اجتذاب التأويل إلى الفكر وإسناده به، خاصة أنّه كان ساريا في معنى النصوص، بما سوّغ الاسترشاد به، ناهيك بخلفية محمد الشركي الفكرية وتكوينه الفلسفيّ الذي يتجلى واضحا في كتابته، وفي بناء شخوصه.
الاستناد إلى نيتشه ودولوز هو استناد إلى قراءة مختلفة لنص يؤسّس اختلافه على عمق الأحياز التي يأتي منها، أحياز ممتدة في عمق الذاكرة الإنسانية، تحتمي بالأسطوري والفكري في بناء متخيل سِمته العمق، ورهانه العود والاستئناف، الذي يوضّحه الشركي بكونه “الحركة الداخلية المتواصلة لأحياز الروح المتنقلة بين الطيات التي لا تنغلق إحداها ظاهريا إلا لكي تفتح الفكر واللغة على طية أخرى تستدعيها إلى حيث يبدو المعنى غير قابل للاستنفاد، أي إلى حيث يتم الإحساس بالعود الأبديّ كعطش لكلمات أخرى قد تقترب أكثر مما ينتظر التسمية”(20).
7.2. شعرية الغامض
الغموض قدَرُ كل كتابة تنتسب إلى الأغوار بأبعادها الروحيّة والأسطوريّة، مثلما هو حال كتابة محمد الشركي. إنّ الغموض ليس خصيصة جماليّة وحسب تتوشح بها الكتابة، بل هو رهان يروم صون المعنى عن الاختزال والاستنفاد. فالوضوح، كلّ وضوح، حاجب. “فما من شيء واضح في الوجود، هي ذي الحكمة التي رسّخها المنجذبون إلى أحياز المجهول وإلى أسرار اللانهائي”(21). من ثم يتوقّف الإدراك والمعرفة على المُعايشة الذوقية بالمعنى العرفاني وليس إلى الحسّ وقد استبلد، وهو أمر يمتدّ أثره إلى القراءة والتأويل في سعيهما إلى القبض على معنى لا يستند “إلى مفهومات نظرية ولا ينمو عبرها، بل ينهض على توقيفها وتوقيف أحكام النظر العقلي وتهييء الحواس للانفصال عن السوى فيها”(22). ليس الغموض بهذا المعنى إلا تعبيرا عن عجز اللغة وقد دُفعت إلى الأقاصي لتقول ما لا ينقال بعبارة النفري(23). ففي لحظة الكتابة يؤكد الشركي “ما من مسافة بيني وبين ذاكرتي وفكري، وما من مسافة بين لغتي وأحياز روحي، ولكنها “لا مسافة” مكتظة بانثناءات لا تنفكّ تستدعي الكلمات ليس لكشفها بل للاستضاءة بالمجهول الغامض فيها”(24).
8.2. كتابة الجسد
تُلامس الكتابة في منجَز محمد الشركي مناطق مولدة للغامض ومُستنبته له. من ثم كان اشتغالها بالجسد، بما هو فضاء تتخلق في تضاريسه معانٍ تكشفُ هشاشة الموجود وقدسيته في آن. إنها كتابة تُحرّر نفسها من القراءات التي سُيِّجت بضيق الثنائيات كما تقدّمت الإشارة (ثنائيات المقدس/ المدنس، الجسد/ الروح…)، ومن تلك المنظورات الاختزاليّة التي تسعى إلى تجريد الجسد من حيويته وقدرته على إنتاج المعنى أو تلك التي حرصت على الفصل بين النفس والجسد، فحطّت من شأن الثاني إعلاءً لشأن الأول.
لقد “كانت علاقة النفس بالبدن قائمة على استعارة علاقة السجين بالسجان، كما كانت حماية النفس من الجسد تتطلب نبذ الغرائز واحتقار النوازع الذاتية، وهذا ما حاربه نيتشه بكلّ قواه، يقول: “يا أخي، يوجد خلف أفكارك ومشاعرك سيّد قويّ، مرشد مجهول إلى سواء السبيل، وهو ما يُدعى الذات عينها. تسكن داخل جسدك، وهي جسدك”(25).
تَستَشكلُ القراءة/ المحاوَرة في كتاب “الأخاديد ونداؤها” موضوع الجسد بالسؤال، لا لتحصيل أجوبة نهائية تغلق النقاش حوله، وإنما بغاية توسيع إمكانَات النظر إليه، فالجواب مُطالب وفق هذه الرؤية بالحفاظ على “ما يستعيد ماهية السؤال التي لا يذيبها ما يُجيب عنه”(26).
ما الذي يَصِل الجسد بالرّوح؟ وكيف يمكن استيعاب كتابة تراهن على الجسد وتراهن في الآن ذاته على جغرافيا الروح؟ ما الذي يمكن أن تضيفه هذه المعرفة بالجسد إلى معرفة متولدة من أحياز الروحي؟
إن ما يهبه الجسَد واعدٌ دائما، لذلك كان الاشتغال بالجسد في كتابة تنتسبُ إلى هذا الأفق حتميّا. فهبَة الجسد، يؤكّد الشركي، ليست نهائية أبدا، لأن الانثناءات الشهوانيّة والعروجات العرفانيّة التي تفتحها هذه الهبَة آن تحقّقها هي أيضا لا نهائية، ولأن كل انثناء موصول بتجويف من تجاويف العالَم اللا متناهية، وكلّ عروج يناديه عروج أعلى منه باتجاه “أرض الحدود” السفليّة والعلوية في الوقت نفسه”(27).
9.2. في أرض الحدود، ضد الحدود
من هذا المدخل الأخير، تأوّلت القراءةُ/ المحاورةُ عملَ محمد الشركي الثالث، الموسوم بـ “السراديب”، انطلاقًا من إنجاز قراءة في نصّ تصدّر هذا العمل، أي النصّ الحامل لعنوان “أرض الحدود”.
ليس الحدّ هنا حاجزا أو حاجبا بل هو ما يصِل الإنسان باللا نهائي وبما لا يُحدّ في تجربة تنتصرُ للغور، “تجربة حدود” بعبارة خالد بلقاسم، الذي حرصَ على اقتفاء ملامح هذه الحدود الموَلِّدة لمعاني الكتابة في نص محمد الشركي. إنّها حدودٌ عليا، فيها يتحقّقُ تماسٌّ عال، وتَكونُ منطقةُ التّماسّ أرضًا لصلاتٍ غائرة، صلاتِ الشهوة بالموت، وصلاتِ الذكورة بالأنوثة، وصِلاتٍ أخرى.
اِنطلقت القراءة المحاوَرة من نص “أرض الحدود” لتعود إليه وقد اغتنت بما يتيحه العَملان السابقان؛ “العشاء السفلي”، و”كهف سهوار ودمها”، اعتمادا على تأويل نسقيّ، يستند إلى ما سبقت الإشارة إليه من خصائص الكتابة عند محمد الشركي، وتحديدًا إلى خاصّتَي الاستئناف والعود الأبديّ.
ما هي أرض الحدود إذًا؟ يجيب محمد الشركي: “هي عمق الأعماق اللامحدودة التي فيها تترابط وتتضام جغرافيات الروحي والجسماني والأرضي والكوني لتحلّ مجتمعة في أحياز الكتابة كما أفهمها، وكما شاء مصيري الشخصي أن أتورط فيها”(28).
تسمحُ مُصاحبة العوالم التي فتحها كتاب “الأخاديد ونداؤها” استنتاج الآتي:
– أهمية الشكل الكتابي الذي يرومُ خالد بلقاسم ترسيخه بوعي نقديّ، وعي يُعيدُ لممارَسةِ الفكر والنقد والأدب ما يُغنيها من حيث تحقُّقها بالمحاوَرة وداخل المحاورة.
– سعيُ هذا الشكل الكتابيّ، القائم على المحاوَرة، إلى بناء تأويلات كلّيّة للأعمال الإبداعية من منظور نسقيّ يُنصتُ للمَتن المُحاوَر في شموليّته.
– ترسيخ الكتابة من منطقة تُقيمُ لقاءً بين الكتابة والقراءة من داخل تردّدِ صوتيْن، بما يتيحُ لهذا اللقاء أن يحتفيَ بالاختلاف، وأن يجعل الاختلاف حاسما في توليد المعنى.
– استثمار القراءة/ المحاوَرة لما تتيحه التأويليّات من مداخل جديدة تُحرّر النصوص من الانغلاق المنهجي، الذي حوّلها إلى وثائق صامتة لا تقول أكثر مما تقوله منطلقات المنهج نفسه.
إنّ المقاربة الحوارية التي يعتمدها خالد بلقاسم تتيح للمُبدع نفسه اكتشاف نصوصه من موقع جديد، موقع القارئ وهو يكتشف لذة القراءة والتأويل في نصّ عاش لذة كتابته.
الهوامش
محمد الشركي، كاتب مغربي ولد بفاس سنة 1958، من أعماله “العشاء السفلي” 1987، “كهف سهوار ودمها” 2001، “السراديب”، 2007.
“فالواحد من أهل الفكر المغاربة لا يحاور غيره، فهو إما يعتزل في برجه العاجي، ظانا أن قوله هو القول الفصل في كل شيء، وإما يتعمد الشذوذ في أقواله، مطبقا القاعدة السارية “خالف تعرف”، وإما أنه إذا اعترض على غيره أبهم اسمه وأخفى عنوانه كما لو أن التصريح بالاسم أو ذكر العنوان تنقيص من منزلته، وإما أنه إذا اعترض عليه غيره، أعرض عن الجواب وحث أصحابه على الإعراض عنه كما لو أن في الرد على الاعتراض قدحا في علمه”، طه عبدالرحمن، حوارات من أجل المستقبل، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2011، ص:9.
يقول المفكر المغربي طه عبدالرحمن: “فإذا كنا ندعو إلى التفكير لا فردا فردا، وإنما جماعة جماعة فلجازم اعتقادنا بأن الحوار، متى دار على معرفة بقواعده وبصيرة بآدابه، من شأنه أن يورثنا من اتساع الأفق وتقليب النظر ما لا يورثه “حديث النفس”، ولو أن حديث النفس هو نفسه حوار مع الذات”. طه عبدالرحمن، الحوار أفقا للفكر، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، ط1، 2013، ص:11.
خالد بلقاسم ومحسن عتيقي، كيليطو، تجويفات، منشورات المتوسط- إيطاليا، ط1، 2024، ص. 7.
نفسه.
موريس بلانشو، أسئلة الكتابة، ترجمة نعيمة بنعبدالعالي، وعبدالسلام بنعبدالعالي، دار توبقال للنشر ط1، 2004، ص10
خالد بلقاسم، الأخاديد ونداؤها، محاورة محمد الشركي في أرض الحدود، منشورات المتوسط ، 2025.
نفسه، ص. 6.
نفسه، ص. 18.
نفسه، ص. 19.
نفسه، ص. 21.
نفسه، ص. 39.
نفسه ص 52
نفسه، ص. 58-59.
محمد بن عبدالجبار النفري، المواقف والمخاطبات، تصحيح ومراجعة آرثر يوحنا بربري، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص. 51.
الأخاديد ونداؤها، م. س.، ص. 68.
نفسه، ص. 87.
نفسه، ص. 93.
” ماذا عساك أن تقول لو أنّ شيطانا تسلّل يوما أو ليلة حتى داخل وحدتك الأكثر انزواء وقال لك: “هاته الحياة، مثلما تحياها الآن، ومثلما حييتها، سيلزمك أن تحياها مرّة أخرى ومرة أخرى ولن يكون فيها شيء جديد، سوى أن كلّ ألم وكلّ متعة، كلّ فكرة وكلّ تأوه وكلّ ما هو متناه في الصِّغر والكبر في حياتك لابدّ أن يعود إليك، والكلّ في نفس النظام ونفس التتابع- تلك الرتيلاء أيضا، وضوء القمر هذا بين الأشجار، وهاته اللحظة وأنا نفسي”. فريديريك نيتشه، العلم المرح، ترجمة وتقديم حسان بورقية- محمد الناجي، إفريقيا الشرق، ط1، 1993، ص.201.
الأخاديد ونداؤها، م. س.، ص. 104.
نفسه، ص. 113.
خالد بلقاسم، الصوفية والفراغ، المركز الثقافي العربي، بيروت – الدار البيضاء، ط1، 2012، ص. 8.
“وقال لي ما ينقال يصرفك إلى القولية والقولية قول والقول حرف والحروف تصريف، وما لا ينقال يشهدك في كلّ شيء تعرفي إليه ويشهدك من كلّ شيء مواضع معرفته”. محمد بن عبدالجبار النفري، المواقف والمخاطبات، م. س.، ص. 59.
الأخاديد ونداؤها، م. س.، ص. 118.
عز العرب الحكيم بناني، الجسم والجسد والهوية الذاتية، عالم الفكر، ع4، 2009، مجلد 37، ص. 114.
أسئلة الكتابة، م. س.، ص. 13.
الأخاديد ونداؤها، م. س.، ص. 153.
نفسه، ص. 173.